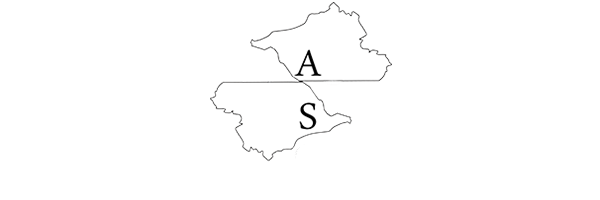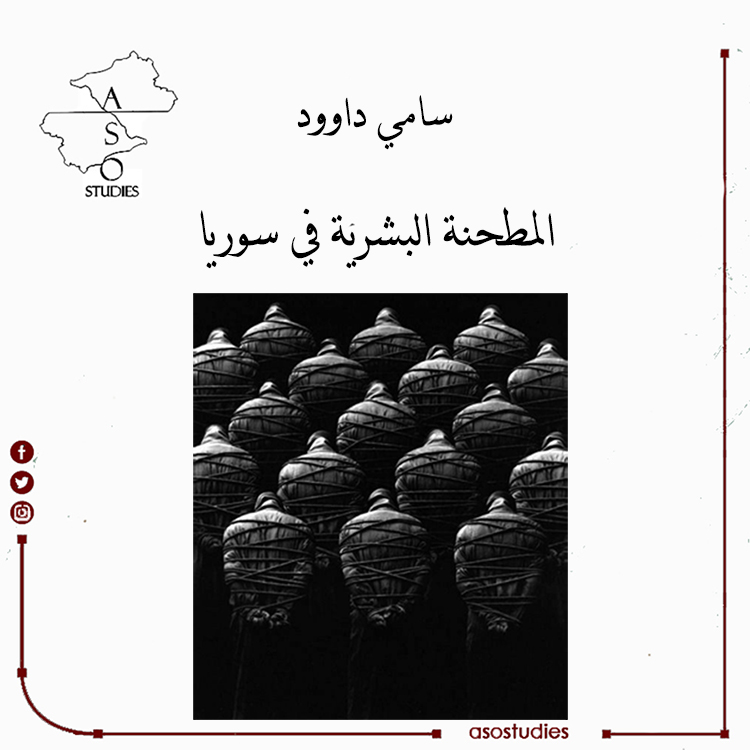المطحنة البشرية في سوريا
سامي داوود
زار المؤرخ الفرنسي فولني (VOLNEY) سوريا ومصر بين عامي 1783 و1785، مدوّنًا ملاحظاته في كتابه "رحلة إلى مصر وسوريا". في تلك الفترة، لم تكن لسوريا هيئة سياسية واضحة ولا هوية ثقافية خاصة. وكانت الشعوب القاطنة في هذه الجغرافيا تُعرَّف وفقًا لخصائصها الإثنية أو المذهبية، كالكُرد، والمسلمين، والمسيحيين، والأيزيديين، والدروز، والعلويين، والإسماعيليين. وكان الاحتلال العثماني يغيّر أسماء التقسيمات الإدارية للولايات، وكذلك مساحاتها.
كتب فولني آنذاك أن السوريين يعاملون بعضهم البعض كأعداء، ويتمايزون وفقًا لتصنيفات متعارضة، تضعهم في حالة حرب دائمة. استخدم فولني التسمية الجغرافية "سوريا" للإشارة إلى فضاء مكاني بلا حدود واضحة، تقطنه شعوب منقسمة، وتنتمي لهويات لا جامع بينها سوى التنكّر لما هو خارجها.
كان الدين آلية حكم، يعمل كروحية سياسية للجماعات الأهلية، وديناميكية عاطفية قابلة للتوظيف العسكري من قِبل الفئة المهيمنة على السلطة. وقد استخدمه العثمانيون والصفويون من خلال تحويل الكيانات المذهبية إلى تقسيمات اجتماعية، وطوّفوا هذه الكيانات سياسيًّا. علمًا أن العنف المذهبي كان قد تكرّس في الانفعالات الدينية الإسلامية عبر ثلاثة قرون متواصلة من الحروب الطاحنة، لخّصها، في تسلسل تاريخي مقتضب، كل من جورج طرابيشي، وفيليب حتّي، وآخرين.
تطوّر الاستثمار في الانفعال الديني بعد الحرب العالمية الأولى. فقد أنشأت اليابان مسجد طوكيو الكبير سنة 1937، وسعت إلى منافسة ألمانيا في السيطرة على المشاعر الدينية، حيث كانت ألمانيا آنذاك أكثر الدول الأوروبية حضورًا في العالم الإسلامي عبر بعثاتها الاستشراقية. وقد ترأس إحدى تلك البعثات موظف في وزارة الخارجية الألمانية يُدعى "ماكس أوبنهايم"، قدّم نفسه كمستشرق مختص بعالم البدو العرب، ودرس خصالهم الحربية وعاداتهم الحياتية في عمل ضخم شاركه فيه مستشرقون ألمان آخرون.
بدأت صورة الإسلام كـ"ديانة حربية" جامحة تلفت نظر هتلر وموسوليني، اللذين كانا على علاقة طيبة بمفتي القدس أمين الحسيني، بحسب ما يذكره الحسيني في مذكراته. وكان هتلر مدركًا لطريقة أتاتورك في استغلال الإسلام للتلاعب بالمشاعر العدوانية. وبدأت هذه الدول في دمج الانفعال الديني بالنشاط العسكري للإمبراطوريات المتحاربة، فظهرت مجددًا عبارة "الأعداء الصليبيين" في الخطاب السياسي، لدى اليابانيين ضد البريطانيين في الهند والصين، ولدى الأتراك والألمان في سوريا ومصر وفلسطين.
علمًا أن التسمية الرومانية "سوريا" ظهرت في القرن الثالث قبل الميلاد، وفقًا لتخمين غير دقيق من قبل هيرودوت. وقد اختفت هذه التسمية من السجلات الرسمية ابتداءً من القرن السابع الميلادي وحتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر، حين ظهرت الـ"سالنامه" العثمانية كتقويم إداري خاص بولاية سوريا سنة 1868، وكانت تشمل حينها فقط مدينة دمشق وصولًا إلى منطقة حوران، بينما ظلت ولاية حلب مستقلة حتى سنة 1925.
تجوّل فولني، على غرار ما فعله مارك سايكس لاحقًا، في سوريا، ممتطيًا الدواب للتنقل بين المدن الريفية الصغيرة. آنذاك، لم تكن هناك مواصلات ولا تعليم في سوريا، وكانت الطرق الرومانية القديمة مدمّرة بفعل الحروب. فتأخر شق الطرق حتى سنة 1883، واقتصر على مساحات ضيقة، رغم بعض المحاولات التنموية السريعة التي قام بها إبراهيم باشا خلال فترة حكمه لسوريا بين عامي 1831 و1840. ومع تفشّي الأمية وانعدام المواصلات، كان من الطبيعي أن تجهل الشعوب السورية بعضها البعض. لذلك، لا توجد أي وثيقة تحمل سِمة مشروع سياسي سوري مشترك.
أما التحوّل في السلطة بعد خروج الاحتلال العثماني سنة 1918، فقد تمّ عبر انتقال السلطة من الولاة العثمانيين إلى "طبقة الأعيان"، بحسب تعبير آلبيرت حوراني. وظلّت السلطة، منذ 1920 وحتى 1949، محصورة في يد 52 عائلة من برجوازية المدن، الذين كانوا امتدادًا لطبقة الموظفين والتجار العثمانيين. وبالتالي، فإن التحوّل في السلطة لم يحدث سنة 1920 مع إيفاد البريطانيين لفيصل بن الشريف حسين من الحجاز إلى دمشق، التي حكمها لسنتين فقط، بل بدأ تدريجيًّا مع التحوّل في السياسات الزراعية، وظهور العقائد الشوفينية في سوريا لدى النخب المتعلّمة، التي تبنّت، بتأثير من المتعصبين القوميين الأتراك والنازيين الألمان، المفهوم البروسي لـ"الأمة المحاربة".
بالإضافة إلى عوامل أخرى، مثل: انتقال الكلية العسكرية من دمشق إلى حمص، وبدء عملية "ترييف" الجيش، وتحويله إلى جيش عقائدي عبر أكرم الحوراني. ناهيك عن التغييرات الاقتصادية التي حدثت في اقتصاد المستعمرات على حساب الدول الاستعمارية، وتطوّر عملية المبادلة التجارية وتصدير بعض المحاصيل الزراعية السورية.
بعد أربعة قرون من الاحتلال العثماني لسوريا، والذي وصفه أرنست رينان بأنه الحقبة التي "قُتل فيها العقل"، وسانده في ذلك أرنولد توينبي في كتابه المشترك مع فيسكونت بيرسي "طغيان الأتراك القاتل – 1917"، أو كما وصفه محمد كرد علي في مذكراته بأن العثمانيين «لم يؤسّسوا مدرسةً ولم يعبدوا طريقًا» – بدأت المدارس تُبنى كامتياز لطبقة الولاة ابتداءً من عام 1884. وذلك لأن سوريا، بالنسبة للعثمانيين، ومن خلال قراءة مذكرات "البديري الحلاق" (1701–1762) مثلاً، لم تكن سوى مصدر للتجنيد والجباية والمؤن.
ومن حقبة الانحطاط العثماني، انتقلت سوريا إلى الانتداب الفرنسي، الذي حرص على إجراء إحصاءات سكانية عديدة، جميعها، لحسن الحظ، متوفرة في مكتبة الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي. كما استحدث بنى مؤسساتية حديثة في مجتمعات مفرطة التجهيل والتفكك، فتحوّلت الولايات السورية إلى دويلات عرقية وطائفية، مزدوجة الإدارة (مندوب سامٍ وحاكم محلّي). ومن الانتداب انتقلت سوريا إلى حكم العسكر، الذي ظلّ مستمرًا دون انقطاع حتى اليوم. علمًا أن الأكراد السوريين كانوا قادة الانقلابات العسكرية، بدءًا بحسني الزعيم عام 1949، وصولًا إلى أديب الشيشكلي، وفوزي سلو، وغيرهم.
حاول الفرنسيون تشكيل دويلة بدوية في البادية السورية، كلّفت خزينة الدولة ملايين الفرنكات التي صُرفت كرشاوى لزعماء بعض العشائر، لكنها فشلت فشلًا ذريعًا. كانت البُنى الثقافية والمجتمعية متعارضة مع فكرة المؤسسة، ولا تزال كذلك حتى اليوم؛ مجتمعات تفضّل الزعامة والمحسوبية القبلية والمذهبية على التعالي إلى المستوى السياسي لفكرة المواطنة.
أذكر هنا مثال الدويلة البدوية في سوريا، لأن تعداد سكان سوريا سنة 1921 كان مليونًا ومئتي ألف نسمة، وحتى سنة 1929، بلغ عدد السكان مليونًا ونصف، منهم أربعمئة ألف بدوي. كان الجهل صلبًا ومستعصيًا على التمأسس المدني، وعملت الشعارات القومية على حجب هذه الوقائع، مثلما يحدث اليوم.
إنّ "سوريا" تعبير جغرافي لشكل سياسي مُصطنع وحديث، يعود إلى سنة 1939. وقد تم ترسيم حدودها بدايةً بقلم رصاص خطّه مارك سايكس على خريطة ورقية في 15 ديسمبر 1915، خلال اجتماع بمكتب Downing Street 10 لرئيس الوزراء البريطاني في لندن. وظلت حدودها متحرّكة عبر سلسلة الاتفاقات التي كانت فرنسا (المحتل الجديد) توقّعها مع الأتراك (المحتل السابق) بين عامي 1921 و1939.
ولأن فرنسا كانت آنذاك تحت الاحتلال الألماني، وشارل ديغول يوجّه خطاباته من لندن إلى النصف الحر من فرنسا وإلى المستعمرات، فقد كان قرار تشكيل الحدود السورية–العراقية–التركية خاضعًا للتحالفات العسكرية لإمبراطوريات ما بعد الحرب العالمية الأولى، ومن ضمنها محاولة الفرنسيين استمالة الأتراك وحثهم على فك ارتباطهم التاريخي مع الألمان. وهكذا، ورغم بنود المعاهدة الفرنسية–السورية سنة 1936، ورغم نتائج الإحصاء الذي نظمته عصبة الأمم في لواء الإسكندرون سنة 1937، منحت فرنسا اللواء لتركيا، وتخلّت مع بريطانيا عن القسم الغربي من الإقليم الكردي، الذي بات رسميًا جزءًا من سوريا.
ويُظهر الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي الوثائق التي توضح التحوّل في السياسة الفرنسية داخل الإقليم الكردي، وكيفية إلحاقه بسوريا.
ذكر السياسي الكردي نور الدين ظاظا في مذكراته أنه، سنة 1940، كان في دمشق فريق كرة قدم يُدعى "كردستان"، وقد حصل على بطولة الشام. ومن خلال مراجعة مرافعات محاميه الثلاثة: عربي من حلب، وعربي من دمشق، وكردي، يظهر حجم التضامن الأخلاقي لدى العرب مع الشعب الكردي حتى سنة 1962. بل ولم أعثر، خلال عملي على تاريخ الكراهية في سوريا، على أي وثيقة تعود إلى ما قبل 1936 وتحمل كراهية بين العرب والكرد. بل على النقيض، كانت الإصدارات العربية في بيروت، والقاهرة، وبغداد، ودمشق تشارك في النضال الكردي لتأسيس كردستان على أرضها.
كما أن أول من طالب بتأسيس سوريا كدولة عربية هو المفكر الكردي عبد الرحمن الكواكبي، بحسب نيكولاس فان دام، نقلًا عن ألبيرت حوراني. وأول من ألغى نظام المحاصصة الإثنية في البرلمان والجيش السوري هو الرئيس الكردي أديب الشيشكلي. وأول مجمع للغة العربية أسسه محمد كرد علي، الكردي المستعرب.
غير أن أفكار المواطن العثماني العروبي ساطع الحصري، وما تلاه عبر ميشيل عفلق، وزكي الأرسوزي، وأكرم الحوراني، الذين استدمجوا حرفيًا الأفكار النازية التي وصلتهم عبر كتاب "خطابات إلى الأمة الألمانية" لـفيخته، المترجم من قبل سامي الجندي – وتظهر فقرات منه كنسخة طبق الأصل في كتاب "الجمهورية المثلى" (1965) للأرسوزي – كل أولئك قاموا بتعريب الإسلام وأسلمة العروبة. وعلى النقيض من قراءة حازم صاغية لفكر الأرسوزي، واعتقاده الخاطئ بأن هذا الأخير كان يستقي نمذجة عقيدته من الجاهلية، فقد جعلوا من العقيدة القومية شيئًا مقدسًا.
وبناءً على ذلك، لم يعد هناك خصوم في سوريا، بل تحوّل كل خصم إلى عدو. كما قال أكرم الحوراني في منهاج حزبه "الشباب" سنة 1937: «كل من لا يُستعرب سيكون دخيلًا على أمته»، وهي الفقرة التي تبنّاها لاحقًا دستور حزب البعث سنة 1947.
تغيّرت المعادلة الثقافية والوجدانية في سوريا بعد استلام البعثيين الحكم سنة 1963. ومنذ تلك اللحظة إلى اليوم، لم تظهر في سوريا ثقافة معارضة للنموذج الشوفيني البعثي، بل تراكمت الشعارات المنادية بتحويل القتلة إلى رموز، كصور صدام حسين وأردوغان المتداخلة بأعلام الجماعات المسلحة السورية، التي ارتكبت، وفقًا لتقرير لجنة التحقيق الأممية المنشور في 15 أيلول 2020، جرائم ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا ضد الأكراد في المدن الكردية المحتلة حتى اليوم من قِبل تركيا.
وقد دأبت التنظيمات السياسية والعسكرية السورية الموالية لتركيا، منذ 10 نوفمبر، على تنظيم حملات تحريض وكراهية ممنهجة ضد الكرد في سوريا، شارك فيها متطرفون علمانيون وسلفيون على حد سواء، تُرجِمت إلى عمليات قتل للمدنيين الكُرد على الهوية في مدينة منبج، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
لم يحدث، في التاريخ السوري القديم أو الحديث، أن تحوّلت الشعوب القاطنة في سوريا إلى أمة واحدة. وعبارة "الشعب السوري" لا تحيل إلى أي مضمون سياسي أو ثقافي، بل هي مجرد مجاز جغرافي لجماعات غير قادرة على التفاعل ثقافيًا وقيميًا لتكوّن أمة متماسكة. وتعيش، منذ عام 2012، حربًا أهلية همجية، وتهجيرًا قسريًا، واحتلالات إقليمية مبنية على ولاءات طائفية سنّية وشيعية، مع جهل مستفحل في جميع الطبقات الاجتماعية، وتركة قمعية يكثفها سجن صيدنايا، تمتد لأكثر من نصف قرن، وثقافة سياسية عشائرية، ونظام سياسي وثقافي لم يتغير منذ عقود.
كما يوجد ميل لاختزال النظام السابق إلى مجرد بعض الأشخاص أو العوائل، وتبديل العصبية المهيمنة – المتطابقة مذهبيًا ومناطقيًا مع فئة ما – بعصبية مهيمنة أخرى، متطابقة عرقيًا ومذهبيًا مع فئة أخرى. وهكذا، يتغير اسم المُهيمن، مع بقاء النزعة القمعية مستقرة في الهيكل السياسي ذاته.
هذه المطحنة البشرية لن تُثمر سوى المزيد من الكراهية. وما يزيد الوضع تعقيدًا، هو أن الكراهية، كفعل قذر وشرير، تجد في سوريا جماعات تتبنّاها كشيء مُستحب. وهي اليوم سلاح خطير في يد تركيا، التي تستغل عملاءها السوريين وتوجّههم في حرب إبادة معلنة ضد الكرد في سوريا.
لن تخرج سوريا من حفرة الكراهية المتجذّرة في أحقاد لا يمكن للعقل تفكيكها بأي خطاب. ثمة هيام بالشر يخيم على سوريا، تترجمه حفلات القتل المتبادل، وسحل الجثث، والتمثيل بها على إيقاع الشعارات المتطرفة.
يجب الاعتراف بأن هذا البلد مُحطّم، والاعتراف بهول الجهل والحقد الذي سيُعطّل، حتمًا، المشاريع السياسية المعلّقة، فكل المؤشرات تفضي إلى العودة الأزلية للعنف المقدّس.