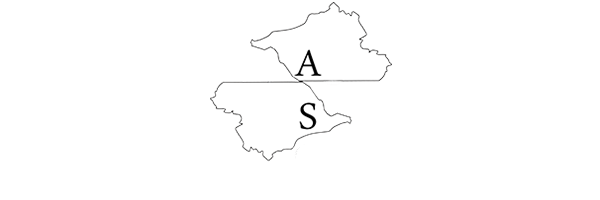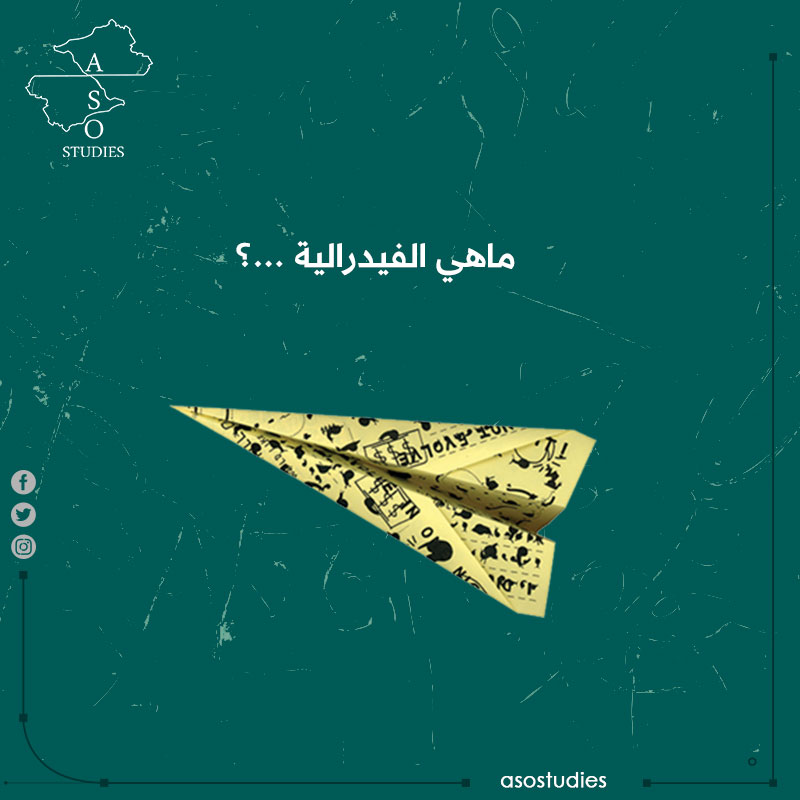ما هي الفيدرالية
تعريفها الإجرائي:
الفيدرالية هي صيغة للحكم التشاركي في المجتمعات المتنوعة إثنياً ودينياً، تتعاهد فيها، بإرادتها الحرة، مجموعةُ الأقاليم المنضوية في إطار دولة موحدة، وتتفق على تقاسم السلطة بين الحكومات المحلية والحكومة الفيدرالية، مع بقاء السياسة الخارجية للدولة بيد السلطات الفيدرالية، دون أن يعني ذلك غياب مساهمة الحكومات المحلية في صياغة هذه السياسة.
تاريخ الفيدرالية:
تتوفر عدة إشارات إلى بدايات ظهور الفيدرالية كشكل من أشكال الحكم التوافقي، غير أن بعض هذه الإحالات تخلط بين النظام الكونفدرالي، كما كان سائداً بين دول المدن (Polis) الإغريقية، أو بين المقاطعات السويسرية قبل إعلان دستورها الفيدرالي عام 1848، حيث كانت تلك التحالفات تنظيماً لشكل من أشكال الحكم الأوليغارشي (حكم القلة) ضمن إطار كونفدرالي، يسعى إلى تنظيم العلاقات بين مقاطعات متمايزة وشبه مستقلة سياسياً وقانونياً.
لذلك، يمكن اعتبار سنة 1787 بداية رسمية لتبني شكل النظام الفيدرالي من قبل المقاطعات الأمريكية الثلاث عشرة. أما في أوروبا، فقد أفرزت اتفاقية وستفاليا عام 1648 نحو 300 مقاطعة إدارية منسجمة مع التصور الإقطاعي للأراضي المملوكة بـ"وضع اليد"، وكانت العلاقة بينها أقرب إلى كونفيدراليات فضفاضة منها إلى دولة موحدة ذات نظام فيدرالي.
تجدر الإشارة إلى أن أشكالاً شبيهة بالنظام الفيدرالي كانت موجودة في الحضارة اليونانية القديمة، مثل "مجلس الأمفكتيويين"، "عصبة الإيخائية"، و"اتحاد الآخائيين" (281–146 ق.م). كما شهدت الحضارة الرومانية وغيرها من الحضارات تحالفات مماثلة.
وقد اعتبر بعض الباحثين أن المفكر الألماني جوهانس ألتوسيوس (1557–1638) هو الأب المؤسس لمفهوم الفيدرالية، والذي روج له في كتابه "السياسة". فيما يُعزى هذا الفضل حديثاً إلى المفكر كي. سي. واير من خلال كتابه المعنون "الحكومة الفيدرالية" الصادر عام 1964.
الأسباب الأساسية لتبني الفيدرالية
تختلف الأسباب التي تدفع الدول إلى تبني شكل الحكم الفيدرالي من تجربة إلى أخرى. فبعض الدول تعتمد الفيدرالية لتعديل مساراتها السياسية، كما حدث في ألمانيا عام 1945، حين تحوّلت من نظام حكم مركزي رئاسي إلى نظام فيدرالي برلماني. وتتبناها دول أخرى لضرورات اقتصادية، كما في تجربة دول أوروبا الشرقية بعد انهيار الأنظمة الشيوعية. بل وتُعتمد الفيدرالية أحياناً لأسباب هوياتية، من خلال اختيار أسماء محايدة عرقياً، كما في تجربة يوغسلافيا عام 1939، أو كما فعل الملك الروماني كارول عام 1938، عندما فرض إعادة تقسيم البلاد إلى عشرة أقاليم جديدة بهدف تفكيك التجمعات العرقية والطائفية.
وفي نيجيريا، أدّت الحاجة إلى النمو الاقتصادي إلى ازدياد عدد الولايات الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد الفيدرالي، وتشكيل تحالفات فيدرالية ذات طابع سياسي واقتصادي. فقد بدأت الفيدرالية النيجيرية بـ12 ولاية في عام 1967، لتصل إلى 29 ولاية بحلول عام 1983.
وقد شهدت العديد من الدول، بعد تبني الفيدرالية، مراحل من التطور والازدهار والتجانس بين شعوبها، حتى بات يُنظر إلى الفيدرالية كنظام يُحتفى بمزاياه. ووفقاً لأحدث الإحصاءات، بلغ عدد الدول التي تعتمد النظام الفيدرالي حول العالم 28 دولة، تضم نحو 40% من سكان الكرة الأرضية، من بينها ثماني دول تُصنّف ضمن أكبر عشر دول من حيث المساحة في العالم (جورج أندرسون – منتدى الدراسات الفيدرالية، ص1).
الجغرافيا والنظام الفيدرالي
ثمّة مغالطة شائعة، خاصة في العالم العربي، تروّج لفكرة أن الترابط الجغرافي بين الأقاليم يُعدّ شرطاً ضرورياً لقيام النظام الفيدرالي. وهذه مغالطة جوهرية. ويمكن دحض هذا الزعم بدايةً من داخل المنطقة العربية، من خلال العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان. إذ تمتلك سلطنة عُمان مدينة تقع داخل الأراضي الإماراتية تُعرف بـ"الدمحاء"، وفي المقابل تمتلك الإمارات مدينة أخرى تقع داخل الأراضي العُمانية، وذلك منذ رسم الحدود بين البلدين بإشراف بريطاني عام 1971.
أما النموذج الأمريكي، فيقدّم مثالاً أكثر وضوحاً في نفي هذا الشرط الجغرافي، إذ تقع أكبر الولايات الأمريكية، "ألاسكا"، خارج الأراضي المتصلة للولايات المتحدة، ويفصلها عنها بلد مستقل هو كندا. وكانت ألاسكا جزءاً من روسيا القيصرية، وقد اشترتها الولايات المتحدة عام 1768 بمبلغ قدره 7.2 مليون دولار، ولم تُصبح ولاية أمريكية رسمياً إلا في عام 1959.
من جهتها، تقدم فرنسا نموذجاً آخر في تعاملها مع الأقاليم التابعة لها ضمن صيغة فيدرالية، حيث تمتلك أقاليم في قارات أخرى تُعرف باسم "الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار".
لذلك، يُعبّر النظام الفيدرالي، في جوهره، عن الإرادة الحرة للانضمام إلى نظام سياسي مشترك، ولا يُشترط فيه الاتصال الجغرافي. ومن هذا المنطلق، تُعتبر الفيدرالية، من وجهة نظر الجغرافيا السياسية، إحدى أنسب السبل لبناء لُحمة وطنية في مجتمعات منقسمة ومتباينة إثنياً ودينياً.
توزيع الاختصاصات في النظام الفيدرالي
تنتهج الدول الفيدرالية عموماً في توزيع سلطاتها منهج اللامركزية السياسية، وهو نظام سياسي ذو أساس دستوري، يختلف في جوهره عن المركزية الإدارية بأنماطها المختلفة، سواء المركزية الإدارية أو اللامركزية الإدارية، باعتبارها أنماطاً إدارية تُمارَس ضمن الدول المركزية لتسيير وظائفها.
وللفيدرالية أشكال متعددة، تُصنَّف إمّا وفقاً لطريقة تشكيلها، أو لقواعد توزيع الاختصاصات ضمنها، أو تبعاً لمسبّباتها وسياق تطبيقها. وتُطبَّق الفيدرالية في أنظمة حكم مختلفة، سواء كانت ملكية أم جمهورية، رئاسية أم شبه رئاسية أو برلمانية، وفي دول غنية وفقيرة، كبيرة أو صغيرة، بل وحتى في دول ذات أقاليم منفصلة جغرافياً.
وتتجلى مظاهر الدولة الفيدرالية في بُعدين:
1. المظهر الخارجي: وهو يشمل اختصاصات الحكومة الفيدرالية في تمثيل الدولة سياسياً ودبلوماسياً على الصعيد الدولي، وإعلان الحرب أو السلم، وإبرام المعاهدات. أما داخلياً، فتشرف الحكومة الفيدرالية على القوات المسلحة وغيرها من المسائل السيادية، مع إمكانية وجود استثناءات دستورية محددة.
2. المظهر الداخلي: تحتفظ فيه الكيانات المكوّنة للدولة بدساتيرها الخاصة، وحكوماتها المحلية، وقوانينها وإداراتها الذاتية.
وتتألف الدولة الفيدرالية من وحدتين سياسيتين: حكومة مركزية (فيدرالية) وحكومات الأقاليم. لكل منهما اختصاصات حصرية ومشتركة. وإلى جانب البرلمان الفيدرالي، توجد برلمانات إقليمية تملك صلاحية سنّ قوانين قد تختلف عن قوانين المركز، شريطة ألا تتعارض مع دستور الدولة والاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية.
وتتولى هيئة قضائية فيدرالية عليا مستقلة، مقرّها في عاصمة الدولة، مسؤولية الرقابة على دستورية القوانين، وحل النزاعات الدستورية المختلفة، وتعلو في أحكامها على كل اعتبار. ويتم اختيار قضاتها بطريقة تضمن النزاهة والشفافية والحياد، وبموافقة مجلس يمثل الوحدات السياسية في الدولة.
أما السلطة التشريعية في الدولة الفيدرالية، فغالباً ما تتألف من هيئة نيابية ثنائية المجلس:
• المجلس الأول يُنتخب من قبل جميع مواطني الدولة ويمثّلهم.
• المجلس الثاني هو مجلس الوحدات السياسية، تتمثل فيه الأقاليم أو الوحدات على قدم المساواة، بغض النظر عن حجمها السكاني أو مساحتها.
عيوب متوقعة
من أبرز العيوب المحتملة للنظام الفيدرالي هو إغفال العلاقة بين التنوع الثقافي ومفهوم الوطنية المفترضة فيه، وعدم تحصين النظام من هيمنة الأغلبية الإثنية أو الدينية على السلطة، عبر الانتخابات، نتيجة للتغيرات الديموغرافية التي قد تمنح فئة معينة الأغلبية العددية. وهو ما وصفه أليكسي دي توكفيل بـ"طغيان الأغلبية"، والذي يُعدّ أحد أسوأ أشكال الاستبداد.
ولمواجهة هذا الإشكال، طوّرت العلوم السياسية مفاهيم مثل حق النقض (الفيتو) والديمقراطية التوافقية، والتي تتيح لحكومات الأقاليم الاعتراض على القوانين التي تتعارض مع مصالحها، بما يضمن نوعاً من التوازن والتكافؤ داخل النظام الفيدرالي.